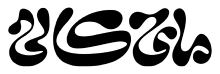بقلم ليلي ب.
تحرير موسى الشديدي
العمل الفني: قبلة يهوذا ، لوحة جدارية تعود إلى القرن الرابع عشر للرسام تريسينسكو في ساكرو سبيكول.
سفر اللاويين 22:18 “لاَ تُضَاجِعْ ذَكَرًا مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ. إِنَّهُ رِجْسٌ” هذه إحدى أولى الآيات التي تعلمتها و قرأتها في صغري أثناء نشأتي في الكنيسة.
كثيراً ما كنت أفكر في قرارة نفسي، ماذا لو أن الله يقبلني كما أنا؟ فتأتي آيات العهد الجديد أيضاً لتّأكيد على نظرة الله لي -أو هذا ما أعتقدته في ذلك الوقت- إنسان يمارس الجنس مع نفس الجنس، غير طاهر ومرفوض من المجتمع ومن دائرتي المجتمعية الدينية تحديداً، حين تقول الآية في رسالة بولس الرسول لأهل رومية 1: 26-27 “لِذلِكَ أَسْلَمَهُمُ اللهُ إِلَى أَهْوَاءِ الْهَوَانِ، لأَنَّ إِنَاثَهُمُ اسْتَبْدَلْنَ الاسْتِعْمَالَ الطَّبِيعِيَّ بِالَّذِي عَلَى خِلاَفِ الطَّبِيعَةِ، وَكَذلِكَ الذُّكُورُ أَيْضًا تَارِكِينَ اسْتِعْمَالَ الأُنْثَى الطَّبِيعِيَّ، اشْتَعَلُوا بِشَهْوَتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَاعِلِينَ الْفَحْشَاءَ ذُكُورًا بِذُكُورٍ، وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ ضَلاَلِهِمِ الْمُحِقَّ” لتتوالى من بعد ذلك سنين التوبة المستمرة والرجاء في “الشفاء” من البلاء. كنت أواظب على الذهاب إلى الكنيسةِ بشكل مستمر، كنت أُمضي أحياناً أياماً عدة ومتوالية من الأسبوع الواحد في الكنيسة المحلية في مدينة نشأتي. غالباً بسبب استمتاعي في حياة الإيمان المسيحي وأحياناً أخرى بسبب احتياجي للشعور بالإنتماء إلى مجموعة ما صغيرة، ضمن المجتمع الأكبر، والسبب الأعمق من ذلك هو شعوري بالقصور الروحي و ضعف موقفي أمام الله؛ لمجرد اختلاف ميولي وممارساتي الجنسية عن بقية الناس من حولي.
لطالما كانت تأتي العظات أيام الأحاد كتنبيه صارخ من قبل الرب على عاري وسري، الذي لم أجرء آنذاك على إفشائه لأحد. فكنت أبكي مراراً و تكراراً راجياً الله أن يغيرني، أن يصنع معجزة من معجزاته ويشفيني، وفي كل مرة كنت اتصادم مع ذات الواقع وكأني لم أغرس ركبتاي في أرض الكنيسة أو حتى في غرفتي ليلاً متأملاً ولو أن يستمع الله لصلاتي، وإن كانت إجابته بالرفض حتى. فكنت أصل إلى مراحل حزن شديدة لمجرد تجاهل طلبي بالتغيير.
استمرت محاولات شفائي الذاتي لسنين عدة، تقرّبت فيها من فتاة؛ إذ كنت أعتقد بأني إن وقعت في غرام إحداهن لشفيت. ولَطَمَني واقعي بأنني ما زلت كما عهدت نفسي! اذكر محاولاتي وفترات صلاتي معها طالبين سوياً التغيير المستحيل ذاك. ولا أنكر أنها كانت إحدى أوائل الأشخاص الذين كشفت لهم عن ميولي وقابلتني بكل صدر رحب. سعيت بعدها لفترات متباعدة عدة أن أطلب المساعدة من أشخاص مختلفين، وكانت تُمَدّ يَدَ العون لي في كل مرة؛ معظم الأحيان بسبب حزنهم/ن على الإنسان الخاطئ الذي في داخلي، الروح الهالكة!
ما تزال إحدى التجارب عالقة في ذهني ليومنا هذا؛ كنت في مجال الخدمات المسيحية للشبيبة الناشئة في مؤتمر تدريبي للمرشدين/ات وكنت ضمن فريق الإرشاد ذاك. في إحدى الجلسات طُرِحَ موضوع الخطايا الخفيّة، ذُكِرَت آيات التوبة إياها وعُزِفَ على وتر مشاعري وقتاً كافيا ليدفعني للإعتراف لأحد قادة المرشدين بهواجس خواطري. تعامل مع الموضوع بهدوء مريبٍ جداً لم أتوقعه، وبّخني بطريقة دبلوماسية واتفق معي على الحل الوحيد الذي لطالما وثقت بقدرته الغير مضمونة؛ الصلاة! ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم دعوتي للانضمام لخدمات الإرشاد تلك في السنوات التي تلت هذه التجربة. لا أعلم إن كانت الأسباب بالضرورة متعلقة باعترافي لذلك القائد أم لا، لكن ما أنا على يقين به أن ممارساتي وميولي كفيلتان بأن يتم إقصائي من أي خدمات دينية في أي مؤسسة مسيحية كانت.
بدأت أفقد الأمل في التغيير، أصبحت واقعياً أكثر من السابق وبنيت قناعة بأن زمن المعجزات التي لطالما سمعت المصلّين في الكنيسة يتغنّون بها ويرجونها عبارة عن قصصٍ دينية لا تحمل من الصحة أكثر من احتمال كونها خرافة كُتِبَت لإقناع البشر بالروحانيات؛ أداة أو وسيلة لتسويق زمن الأنبياء على أنه قابل للتطبيق في يومنا هذا.
كنت قد سئمت من إقناع المؤسسة الدينية لي بأنني ضعيف واستوجب المساعدة وغير قادر على المضي قدما لوحدي، فقط بسبب ميولي وممارساتي. وهنا بدأت بالتساؤل: أحقاً قال الله ما سبق وتعلّمته من تلك الآيات عن الأشخاص ذوي الميول والممارسات الجنسية المثلية؟ كانت إحدى محاولاتي للتمرد على المؤسسة الدينية وغياب تقبل الإختلاف فيها هو بثقب إحدى أذناي وارتداء الأقراط. قمت بسؤال راعي الكنيسة في ذلك الحين عن ما إن كان ليسمح لي بالتردد على الكنيسة وحضور العظات الرعوية مرتدياً الأقراط في أذني، وبالطبع قُوبِلتُ برفض شديد. خيّرَني بين التخلي عن الكنيسة أو التخلي عن قرطي. حينها أدركت أن المجرى الذي آلت إليه حياتي لا يتناسب مع أفكاري وهويتي وطريقة تعبيري عن ذاتي.
وقتها تخليت عن الكنيسة تماما ولكن تبقّى أجزاء من إيماني لتُمَزّقني بين الفينة والأخرى. ومرت أيامي وكبرت وتعلمت وتعرفت على أشخاص مُتَقَبّلين ومُتَصالحين مع ذواتهم، أشخاص لا يخافون أنفسهم ولا يخافون الحقيقة التي بدواخلهم. عندها رأيت المحبة غير المشروطة التي لطالما كان مؤمنو الكنيسة يتفاخرون بها، إنما تلك المحبة كانت تنبع ممن يعتبرهم الإيمان المسيحي هالكين و مستحقين الموت. نبعت المحبة غير المشروطة من هؤلاء الذين يصفهم الكتاب المقدس بالضّالين و الزناة و الفاسقين.
قمت بسؤال راعي الكنيسة في ذلك الحين عن ما إن كان ليسمح لي بالتردد على الكنيسة و حضور العظات الرعوية مرتدياً الأقراط في أذني، و بالطبع قُوبِلتُ برفض شديد. خيّرَني بين التخلي عن الكنيسة أو التخلي عن قرطي.
عندما نظرت فيما إن كان الأشخاص الذين شاركتهم بميولي وممارساتي الجنسية في الكنائس مساحة آمان لي، للوهلة الأولى اعتقدت بأنهم كانوا كذلك إذ استطعت من خلالهم الشعور بالاطمئنان. لكن في حقيقة الأمر لم يكونوا مساحة آمنة لي على الإطلاق، لا بل كانوا منصة مصغّرة للمؤسسة الدينية و امتداداً للرفض القاطع لجميع الميول والممارسات الجنسية المختلفة عن الغيرية المعيارية التي يشجعها الدين. فعند غياب التقبّل غير المشروط وحضور الردود المحثّة على الصلاة وطلب التغيير، فذلك شكل من أشكال الرفض والقمع؛ رفض مبطن.
أدرك محدودية الخطاب السابق لسبب واحد؛ أن هؤلاء الأفراد ليسوا بالضرورة مُمثّلين للإيمان المسيحي أو الله تحديداً. و أنهم قد طرحوا حلول الصلاة لأنّي كنت قد طلبت و سعيت لذلك التغيير مسبقاً. لكن هنا يبقى السؤال؛ أليس الإيمان المسيحي يشجع ويعلّم “المحبة والقبول اللا مشروط”؟ أليس الله مُحِب و غَفور و رحيم؟ عند التأمّل في هذه الأسئلة وغيرها يدرك المرء أن الله قد يكون بالفعل مُحِب، لكن تضارب محبة الله و آيات الكتاب المقدس الصارخة بمصير الهلاك لأمثالي، ينتج تخبطات روحية و وجودية لا مفر منها.
البعض قرروا البوح بسر ممارساتهم/هن وهويتهم/ن لرعاة كنائسهم/ن، متأملين/ات إيجاد مساحة آمنة لهم للنمو وربما أيضاً “الشفاء” أو على الأقل حلول لأزمتهم/ن، إن حالفهم/ن الحظ! وفَوْرَ بَوحهم/ن بما في داخلهم/ن تحوّلت تلك المِساحات المُحبّة والآمنة إلى مساحات إدانة واتهام ورفض. بعضهم/ن حُرِموا/ن من أن يَخدِموا/ن في كنائسهم/ن بحُجة أنهم/ن غير صحيحين/ات أو مؤهلين/لات لخدمة غيرهم/ن بينما هم/ن “يعانوا” من “ذلك” الأمر. البعض خَضَعَ لجلسات مشورة وإرشاد لمحاولة شفائهم/ن وتعرضوا/ن لإيذاء نفسي ورفض من مرشديهم/ن. تم اقناعهم/ن بضرورة ذهابهم/ن لتلك الجلسات إذ أن خلاصهم/ن يكمن فيها. تعرضوا/ن لابتزازٍ و استغلال مادي؛ إذ أن بعضهم/ن كان/ت ت/يجبر على البدء بجلسات المشورة تلك من جديد فقط لمجرد أنهم/ن “وقعوا” في فخ إغراء الخطية مرة واحدة مما كان يعني أن عليهم/ن الدفع لتلك الجلسات المكلفة و كأنهم/ن لم يبذلوا أي مجهود مادياً كان أو غير ذلك. استهلكوا/ن عاطفياً وغسلت أدمغتهم/ن بأنهم/ن ليسوا جيدين/ات بما فيه الكفاية ليكونوا جزءاً من شعب الكنيسة العامل والخادم لبناء المجتمع المسيحي.
لا أندم على سنين إيماني بتاتاً، لا بل العكس تماماً. اعتقد بضرورة تجربتي الروّحية هذه لاهمية الدور الذي لعبته في تشكيل هويتي على ما هي عليه اليوم. فها أنا أجلس أمام شاشتي الصغيرة، بجسدي الذي تحول خلال سنوات إيماني المغموس بالتمرد، إلى لوحة فنية تحوي آيات موشومة كنوع من التذكار لماضٍ كان حجر أساس لحاضر ومستقبل يسعى لتقبل الآخر مهما كان/ت مختلف/ة عني!
رأيت الله في خليقته أكثر وضوحاً مما هو عليه في الكنيسة. مصالحتي مع ذاتي لم تكن سهلة أبدا، لكن لم تكن مستحيلة مثل طلبتي بالشفاء خلال سنين صلواتي. قبول المجتمع المسيحي والكنيسة كان مشروطاً بالتغيير ومغلفاً بمحبة لا أعلم بعد لغاية اليوم إن كانت بالفعل صادقة أم كانت مجرد شعارات اعتادوا أن يرددوها فقط. إنه لأمر سهل أن تحب من ت/يشبهكَ/كِ أو ت/يوافقكَ/كِ الرأي، لكن الامتحان العملي للمحبة الحقيقية هو أن تحب وتحتوي وتحترم من ت/يختلف عنكَ/كِ. لذلك قال السيد المسيح في إنجيل يوحنا 13: 34: “وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أُعْطِيكُمْ: أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا.”
عندها رأيت المحبة غير المشروطة التي لطالما كان مؤمنو الكنيسة يتفاخرون بها، إنما تلك المحبة كانت تنبع ممن يعتبرهم الإيمان المسيحي هالكين و مستحقين الموت. نبعت المحبة غير المشروطة من هؤلاء الذين يصفهم الكتاب المقدس بالضّالين و الزناة و الفاسقين.
(جميع آيات الكتاب المقدس المذكورة في المقال أخذت من ترجمة Arabic Van Dyck Bible و قد ترجم من اللغات الأصلية. و كل اقتباس كتب مع شاهده من الكتاب المقدس، مع رقم الإصحاح و رقم الآية تحديداً.)