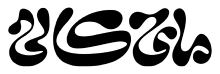بقلم أيمن هدى منعم
الصورة: أيمن (يمين) و نجم (يسار). © أكرم زعتري ، مأخوذة عن هاشم المدني ومؤسسة العربية للصورة، بيروت
هذا المقال من ملف عدد ‘الزواج و الأعراس’ – هيكل العدد هنا
في مصر وبعض دول الخليج العربي يحتكر حفل الزواج مسمى ‘الفرح’، والتسمية هنا لا تبدو فعلاً بريئاً أو محايداً، بقدر ما تهدف لتثبيت الصورة النهائية التي تراها الهيئة الاجتماعية الممثلة بالدولة والمؤسسة الدينية مقبولة، والتي لا مكان فيها للفرد غير المرتبط. ويتخذ الاقصاء بعداً أعمق بتعبير “دخول الدنيا” لوصف الإقدام على الزواج، فيما ليلة الحناء تحفر عميقاً في المخيال الجمعي الرمزي لتصل الأسطورة الفرعونية التي صبغت يدي إيزيس بالأحمر وهي تجمع أشلاء زوجها إيوزريس١. وحال مصر الذي لا يختلف عن غيره من بلدان المنطقة يكفي لتبيان الحيز الذي تحتله مؤسسة الزواج في البنى الرمزية والروحية العميقة لشعوبها والبشرية عموماً.
الزواج الذي رافق التطور الإنساني بصيغٍ ونماذج متعددة وصولاً لشكله الحالي باعتباره الإطار الأكثر قبولاً للالتزام بعلاقة جنسية/عاطفية بين رجل وامرأة بهدف إنشاء عائلة، والمنفذ الوحيد لنيل الحقوق والاعتراف من السلطة، اتسع في سياق التغيير الذي أصاب بنى المجتمع في الغرب ليشمل الزواج المثلي باعتباره الطريق الوحيد والأمثل لتأسيس اتحادٍ بين فردين معترفٍ به قانونياً ومدعومٍ من مؤسسات المجتمع، يضمن لطرفيه الحماية القانونية والتمتع بجملة المنافع والحقوق المقرة لمؤسسة الزواج الغيري.
ورغم استناد مفهوم حقوق الإنسان لقيم الحرية والمساواة دونما تمييزٍ من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب الجنس، دون أن يحدد مساراً أو مراحل محددة لتكريس تلك القيم، فإنه وفي سياق المركزية والرؤية الثنائية الصراعية الغربية للإنسانية – الغرب ضد بقية العالم – يتم تقديم الحق بالزواج المثلي باعتباره الذروة التي يجب على أي نضالٍ حقوقي أن يبلغها، في تمثيلٍ مكتمل الأركان لعولمة حقوق الإنسان. أي الفرض الانفرادي المستند إلى مرجعية تخص حضارة أو مرحلةً تاريخية معينة، واعتباره المفهوم الأسمى واجب التطبيق، ما يناقض جوهر هذه الحقوق كطموحٍ بارتقاءٍ مشترك لتجارب شعوب العالم المختلفة نحو ما هو كوني وعالمي٢.
لكن تحكم الخطاب الغربي بالتصورات الثقافية والوعي العام بمفاهيم الحقوق والحريات عالمياً، وتعميمه لنماذج محددة للعلاقات الاجتماعية، لم يمنع أن يجادل البعض بأن تشريع الزواج المثلي في حقيقته استمرارٌ لأعتى أشكال السيطرة وأقدمها ربما، أي السيطرة على الجنسانية وقولبة الحقوق الجنسية للأفراد من خلال تحريمها أو تحليلها وفق نماذج وممارسات وأطر معينة، وضمن ثنائية المذكر والمؤنث التي لم تكن الوحيدة في التاريخ البشري. وتطويعٌ أو تدجين لمجتمع الميم – عين ضمن مؤسسة الأسرة وإلحاقه بالنظام الأبوي الذي أسسته وتعيد إنتاجه المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية ، بما يضمن استمرار الهياكل الحاكمة للمجتمع كالحكومات والنظام التعليمي والمؤسسات التجارية والتعليمية وجملة القوانين المحكومة بعلاقات القوة المفروضة على الطرف الأضعف كالنساء والأقليات الجنسية.
ووفق الشكل الذي أنجز به، فإن الزواج المثلي أيضاً تمثيلٌ لقوانين الضبط الاجتماعي التي دائماً ما تواجه بها الهيئة الاجتماعية عمليات التغيير والتحولات الكبرى عبر نمطين أساسيين من الضوابط، العقاب المتمثل بعدم الاعتراف والنبذ والتجاهل الاجتماعي والقانوني، والثواب المتمثل هنا بالحقوق المادية والاجتماعية الممنوحة من الدولة للملتزمين بمعايير الجماعة وتصورها للسلوك الإنساني وللتكوين الاجتماعي بنموذج الأسرة النواة، الذي سعت النيوليبرالية المتحالفة مفاهيمياً وعملياً مع المحافظة الاجتماعية منذ سبعينيات القرن الفائت لإعادة تكريسه كوحدة أساسية للحياة الاجتماعية، يُعاد من خلالها إنتاج الطبقة العاملة الجديدة لتعزيز الإنتاج والتراكم، وترسيخ النموذج الاستهلاكي الأكثر مطابقةً لآليات الإنتاج وتوزيع السلع، وثقافة الاستهلاك عموماً٣.
ثقافة الميم…
وعليه يبدو الإصرار على استنساخ مؤسسة الزواج الغيري احتواءً لمجتمع الميم – عين ونقله من موقعه التقليدي خارج المؤسسة العتيقة التي تمثلها الأسرة وما يحيط بها من التصورات والأدوار المجتمعية المتوارثة، لإدخاله تحت مظلة النظام الأبوي الغيري، والتصور الغيري المعياري الثابت لشكل وطبيعة العلاقات الاجتماعية في إطار الحداثة التي يفترض أنها النقيض الجدلي لمفهوم الأبوية الذي حل مكانه تاريخياً. كذلك تغيير طبيعة هذا المجتمع الذي سواء بإرادة أفراده أو بفعل العنف السياسي – الاجتماعي والديني الموجه ضدهم خلق عبر تاريخه حيزاً اجتماعياً خاصاً، وطرح بنى اجتماعية وضوابط جديدة تتجاوز الأسرة النواة وتقدم تعريفاً جديداً للروابط الأسرية التي لا تستند لرابط الدم أو الاعتراف القانوني – المؤسسي، بل لقيم المساواة وحرية الاختيار والعدالة، بحيث شكلت شبكات الدعم والمناصرة التي ابتدعها أبناءه وعلى اختلاف مستوياتها روابط انسانية يتشارك أعضاءها الأمان والاستقلالية معاً، وأسست لبنى ثقافية عالمية عرفت لاحقاً بثقافة الميم.
وبعد مرور عقدين تقريباً على أول تشريعٍ للزواج المثلي في هولندا٤، يمكننا القول بأننا نشهد انحسار ثقافة الميم والمؤسسات والأعراف الثقافية التي ارتبطت بها لعقود، فتشريع الزواج المثلي قانوناً وحالة المقبولية التي وفرها قلص حاجة أبناء مجتمع الميم – عين للانخراط أو الانتماء لمجموعاتٍ قائمةٍ على الميول الجنسية لصالح انتماءاتهم الاقتصادية والسياسية، (وكأن هذه التشريعات كشفت لنا طبقية الصراع) وقلص أيضاً حاجتهم للتنظيم والنضال المجتمعي من أجل الحقوق وقبول مختلف التوجهات٥، فتحولت فعالياتهم المطلبية في الأساس لاحتفاليات وفعاليات تجارية.
في المقابل لم يحمل تعميم النموذج الذي أنتجته الأنساق الثقافية الغربية أي أثرٍ إيجابي للمجتمعات الأخرى. ففي كوبا مثلاً وسعياً للانفتاح على الأسواق والاستثمار الخارجي، أقر النظام الحاكم عام 2018 تعديلاً دستورياً شمل الحق في الزواج وأنشأ لجنة لإقرار الزواج المثلي خلال عامين٦، في حين لم يتضمن التعديل أي تغيير في طبيعة النظام السياسي ومنظومة الحقوق والحريات ولم ينتج أي تغيرٍ في سلوك الدولة ومؤسساتها فمنعت مسيرة الفخر المثلي عام 2019 ومارست العنف الجسدي والاعتقال بحق مخالفي المنع٧، ولا تزال ترفض التعامل مع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ستينيات القرن الماضي وراح ضحيتها 800 مثلي في معسكرات العمل القسري وإعادة التأهيل، مكتفيةً بإقرار الرئيس الأسبق فيديل كاسترو بها٨ كبديلٍ عن الاعتذار الرسمي وآليات التعويض والعدالة، ليبدو أن الاحتفاء الإعلامي الدولي بالتعديل كان احتفالاً بانتصارٍ قبل انجازه.
“تحكم الخطاب الغربي بالتصورات الثقافية والوعي العام بمفاهيم الحقوق والحريات عالمياً، وتعميمه لنماذج محددة للعلاقات الاجتماعية، لم يمنع أن يجادل البعض بأن تشريع الزواج المثلي في حقيقته استمرارٌ لأعتى أشكال السيطرة وأقدمها ربما،”

نجم مع فستان الزفاف. تصوير هاشم المدني، ستوديو شهرزاد، صيدا، 1950s
في بلادنا…
في بلادنا يبدو الحديث عن الزواج المثلي أو إقراره في غير محله، بالنظر للثقافة السائدة التي تنظر للجنسانية عموماً من منظور التحريم وللاستثناء الذي تعيشه الشعوب الناطقة بالعربية المتمثل في قدرة النظام الأبوي على مقاومة التغيير، والحفاظ على بنيته وقيمه التقليدية وروابط الدم والأسرة والقبيلة، كبنى اجتماعية ونفسية راسخة تحكم السلطة والمجتمع، ضمن تصورٍ هرمي قائم على التسلط والخضوع اللاعقلاني المتعارض مع قيم المساواة والحرية والحداثة عموماً، ولعل النظام العربي من بين قلةٍ متبقية لا زالت تطلق على الحاكم لقب الأب القائد المحمل بوجوب الولاء المطلق له من أبناءه المواطنين.
لكن التأخر الاجتماعي في المنطقة واستحالة تشريع الزواج المثلي وعدم راهنيته كما الجدل المحيط بالفكرة أصلاً لم تمنع من أن يشغل الموضوع حيزاً معتبراً من النقاش العام، بفعل الهيمنة المعرفية الغربية والقصور الفاضح في إنتاج فضاءات معرفية وطنية معاصرة، حتى بات أي تشريعٍ للزواج المثلي سواء بقرارٍ سلطوي أو عبر استفتاءٍ شعبي. وفي أي بقعة من العالم مدعاةً للاحتفال ونشر ألوان قرس قزح على منصات الفضاء الإلكتروني الذي يسيطر أيضاً على جزء معتبر من مقدراتنا المعرفية، ويرسم الخط المحدد لأنماط السلوك المقبولة، والذي رغم مساحات الحرية التي يوفرها لأبناء مجتمع الميم\عين في المنطقة، فإنه غالباً ما يحصر نضالهم في إطار التعاطف والاحتفالية المستنسخة والترميز والإشارة فقط. في الوقت ذاته غالبا ما تستغل الدولة حساسية الأمر حتى تعتقل أفرادا من مجتمع الميم بحجة أنهم يقيمون زواجا مثليا في دولنا كما في موريتانيا ومصر في السنوات الماضية وتصويره على أنه مطلب أي حركة حقوقية مثلية اختزالا لأي توعية تتم في بلادنا حول المثلية.
ويتخطى الاحتفاء بتشريع الزواج باعتباره الذروة التي يجب أن يبلغها النضال الحقوقي الفضاء الافتراضي، ليتم تبنيه بشكلٍ قطعي وحتمي من قبل طيفٍ واسعٍ من الهيئات والأفراد الفاعلين في شؤون الجنسانية والأقليات الجنسية في المنطقة، ما يراه البعض انعكاساً لطبيعة عمل هذه الهيئات في ظل غياب الأرضية اللازمة للبناء الديمقراطي الحداثي، والانفصال الواضح بين الخطاب الذي تتبناه ومشكلات المجتمع الحقيقية، إضافة لارتباطها بفئاتٍ اجتماعيةٍ مدنية بعيدة عن ثقافة الغالبية، أي الطبقة الجديدة التي ارتقت لرئاسة الهيئات الممولة غربياً، وتتبنى الخطاب الليبرالي الغربي حول الحقوق الشخصية والمدنية الذي تدور في فلكه المؤسسات البحثية والإعلامية وشبكات المناصرة حول العالم.
تبني الخطاب السابق وبالنظر لتعقيدات المرحلة الراهنة يعني عزل نضال أبناء مجتمع الميم\عين وتأطيره في مسارٍ محدد الأهداف ووفق صيغٍ محددة، وتجاهل سلسلةٍ غير منتهية من صور القمع المجتمعي وصراعات البقاء الاقتصادية التي يعيشها أبناءه، إذ أنه وبنظرةٍ أكثر شمولية لا تنحصر مشكلة أبناء هذا المجتمع بالتجريم أو غياب الاعتراف والحقوق، بقدر ما هي تقاطعات لأشكال وأنظمة القهر والهيمنة والتمييز القائمة على العرق والدين والطبقة الاقتصادية والاجتماعية، كما الميل الجنسي والتوجه الجندري. في حين أنه وفي خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة لا يمكن فصل نضال الميم\عين عن حركات التغيير التي انخرط قسمٌ كبيرٌ من أبناءه في صفوفها للمساواة والمواطنة الكاملة والفعلية والاعتراف بالحقوق والحريات، فيما يبدو مساراً حتمياً لتفكيك السلطة الأبوية والقواعد العرفية الراسخة في المجتمع، وسحب ذريعة أي قمعٍ اجتماعي مؤسس على العلاقات والأدوار الجندرية المرسومة وصولاً لإلغاء الاضطهاد القانوني المتمثل بالقوانين الوضعية.