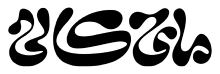بقلم: حمزة ميسرة
تصوير ندى سرحان
العمل الفني: لينا أ.
هذا المقال من ملف ‘يا ليل يا عين’ – هيكل العدد هنا
كنت أشعر بالذّنب في كل مرّة كانت تصطحبني والدتي من أجل شراء الأحذية في مراهقتي. 45، 46، 47، حتى عمر السّادسة عشر. كنت أرى الحيرة في عينيها والصّدمة على وجه البائع “والله يختي ما عنّا من هدا المقاس!”. كنّا نحوم في أسواق المدينة بحثاً عن هذه المقاسات التي لم تصنعها إلّا القليل من الماركات العالمية غالية الثّمن، خارج قدرة عائلتي الماديّة وقتها.
تبعني هذا الخجل حتى بعد سن الرّشد لاكتشافي في عمر الثانية والثلاثين، بالصّدفة، بأنّي كنت ارتدي المقاس الخاطئ كل هذه السّنوات. وبين أقدامي العملاقة من جهة، مقاس ما بين ال49 وال50، والمفلطحة flat feet من جهة أخرى، أصبحت زيارات محال الأحذية أكثر صعوبة، رحلة بحث عن كنز مرهقة نفسيّاً وماديّاً. كل سؤال للقياسات الموجودة والخروج قبل سماع الإجابة يطرق في جسدي أجراس الرّفض والإقصاء التي يرتعد منها. وأحاول تهدئة قدمي المتشنّجتين بعد كل هذه السّنين من الحشو في قوالب لا تناسبها لا تجلب سوى الانكماش والتّصلب والتقرّح وفقدان التوازن، قوالب مصنوعة في الطرف الآخر من العالم على خطوط ماكينات التّصنيع المؤتمتة، لا دراية لها بمقاسي وبشكل أقدامي. هذا غير نظرات الباعة والزّبائن لي كمسخ مختبىئ وراء وجه خجول حسن المظهر لا يعرف كيف يردّ على كلمات الإطراء المبهمّة التي يتلقّاها هنا وهناك.
أحياناً بعد جولة طويلة من البحث بدون نتائج أجد نفسي سارحاً وعائداً إلى زمن جدودنا، حين كانت النّاس من مختلف الطّبقات والخلفيات تذهب إلى صانع الأحذية الّذي كان يفصّل لكل زبون حسب شاكلة جسده وسيقانه وأقدامه. كيف أصبحت هذه العملية ترف لا يستطيع الحصول عليه إلا قلّة من كبار الأغنياء؟ جاءت الصّين وغيرها من الدّول النّامية وسفن الشّحن والتّجارة العالمية وتَضخّم كل ما لا يمكن قولبته وإعادة إنتاجه وتصنيعه. كيف أصبح الوجود خارج القالب ترفاً لا يستطيع دفع ثمنه سوى قلّة قليلة!
بعيداً عن الأسواق العالميةّ، تزامن هذا الاكتشاف مع حالة طبيّة من الدّوالي في خصيتي الشِّمال. فأنا ولدت أيضاً بخصيتين هاجرتين، أو بالأحرى تم تهجيرهما تبعاً لعملية بعمر السّنتين، لإنزال خصيتاي الخجولتين من داخل جوفي إلى مكانهما الصّحي والطبيعي في كيس الصّفن. تبع هذه العمليّة صمت وفقدان ذاكرة إجباريين. حيث أصبحت هذه العمليّة فيل في الغرفة يتفادى والدي النّظر إليه، ويحاولان المزاح حوله، محاولين إقناع نفسيهما بأن طفلهما “طبيعي”، “ولد زي كل الولاد، رح يكبر ويصير زلمة”. طبعاً هذا الخليط من الخوف، والذّنب، والخجل، وربّما جرعة خفيفة من العار المختبئ وراء المصطلحات الطّبيّة والبيتي-فور مع الشّاي والمزاح الثّقيل في الجلسات العائليّة مع الأصدقاء والأقارب، تبلور على شاكلة منطقة وتاريخ محرّمين يرفض الجميع التّطرق إليهما. ربّما خوفاً على نفسيّتي وثقتي بنفسي وبرجولتي. على كلٍ لم تكن والدتي تحب شراء الكعك والبيتي-فور الجاهزين. كانت دائماً تحب صنع الحلوى والمأكولات بنفسها، بيديها، تتأكد من المكونات وطريقة الخلط والتخمير والعجن، وتهتم بكل التّفاصيل وتحتفي بفخر كبير بقدرتها على التّفوق على ربّات المنازل الأخريات.
النتيجة كانت طفولة حافلة بألم الدّوالي غير المشخّص تبعتها آلام نفسيّة تجسدّت بقولون عصبي تارة، والتهاب عنيف ذهبت ضحيته الزائدة الدّودية بعمر الثامنة تارة أخرى. لم يستطع أفضل أطّباء وأخصائيي عمّان تشخيص ومتابعة حالة عامة تصيب حوالي 3 % من المواليد الذّكور المكتملين النّمو، وحتّى 30% في حالة الخداج في حالة الخصاوي الهاجرة1، و حتّى 40 % في حالة الدّوالي2. كان يمكن القيام بفحوص روتينية كانت وفرت عليّ وعلى عائلتي سنين من الشّقاق واللّوم، عشرات الزّيارات الطّبيّة والمخبريّة، والآلاف من الدّنانير التي لم تكن بحوزة عائلتي.
لازلت لهذا اليوم وأنا أذكر طبيب باطني مختص صديق لوالدي وهو يوجّه أصابع الاتّهام إلي بشكل مسرحي في عيادته ويصرخ في وجهي أمام والدي شيئاً كالتالي: “إنت واحد دلّوع ومجنّن أهلك!”، وأنا لم أتجاوز العاشرة بعد. تكوّم هذا الألم مع شعور مضاعف بالذّنب والاتّهامات المتصاعدة من قبل إخوتي وحلفائهم في العائلة وفي الحيّ بأنّي أفتعل كل هذا من أجل سرقة انتباه والديّ منهم، ولسرقة أموالهما على شكل فواتير العيادات والكشوفات والاختبارات الطّبيّة.
حتى أسناني لم تسلم! جاء السّكر كصديق سوء يرافقني في نوبات القلق والذّنب، ومخدّر متاح وسهل يأخذني بعيداً، ولو لبرهة، عن المواجهات وإلصاق الاتهامات والتّبريرات. بعد اتفاقيّات التّجارة الحرة مع الولايات المتحدة وغيرها من رعاة السّلام والوئام العالمي، امتلأت أسواق عمّان بنكهات وألوان وأصباغ عدّة كنّا نراها في المسلسلات الأمريكية، أو نتذوق عيّنات صغيرة منها حالما كانت تخرج من حقائب الأقارب العائدين من الخليج. وبينما كان السّكر يغذّي السّوس الذي كان ينخر أسناني، كنت أصّك هذه الأسنان في نومي وأخفي آلام بطني وقدمي بآلام “حلوة” جديدة. بالتّوازي، كنت أهرب من كرة القدم، والمصارعة، وما شابهها من طقوس الذّكورة التي لم أجد الرّيش الكافي لممارستها. التجأت إلى المشي والتّنزه وتعلّم اللّغات، وحتى ركوب الدّراجة الهوائية وممارسة التزحلق على العجلات (roller skates)، والرّسم والتصوير. بالأحرى، إلى كل النّشاطات الفردية بعيداّ عن الأفرقة والتّنافس الفجّ.
في هذه الأثناء شبح أخي الأكبر مختبئ في خلفية بعيدة، ينظر إلي بأقدامه الأكبر بعد، وقدرته على إجبار أهلي على شراء أحذية مناسبة مرتفعة الثمن من تلك التي أبحث عنها أيضاً بطوله الفارع وعينيه الزرقاويين، بشرته الزيتونية البراقة وجسده الرّياضي الذي لا يتوقف بين كرة القدم والسّلة والتّخييم وغيرها من النّشاطات، هذا وقدرته على لفت انتباه كل البنات، بينما يتم اتّهامي بأني بنّوتة. حتى كونه في مدرسة حكوميّة وتحميلي ذنب تسجيلي في مدرسة خاصّة من بعيد وبشكل غير مباشر كتبرير لماذا أنا لا أستحق الراحة والعاطفة في آلامي. لا يسعني بعد كل هذا الزمن وهذه المسافات في غربتنا سوى استحضار بعض هذه اللحظات بيني وبين أهلي وأخوتي كعرض أدائي هزلي، يحمل كل فرد فيه مرآة سحرية تعكس للفرد المقابل صورة صارخة وفظّة عن آلامه وفقدانه الشعور بالأمان والثقة، بينما لا يرى من يحمل المرآة بشاعة الأذى الذي يشارك فيه من خلف المرآة التي يحملها. ولا يرى هو نفسه آلامه ومشاعره بشكل صريح وواضح مع نفسه ليواجهها ويتعامل معها بعقلانية وبمؤازرة أفراد عائلته، لا بل ويكبتها ويهرب منها. ها أنا الآن راشد في بلد بعيد، أحاول إعادة اكتشاف جسدي والاتصال به، بتُّ لا أعرف إن كان علي البكاء أو الضّحك على هذه الذكريات؟

العمل الفني: لينا أ.
لليوم بالكاد أكون راقص هاوي وليس في سجلّي أي عمل، عدا ربما أسابيع طويلة من تدريب الدبّكة الجماعية في الإعدادي من أجل حفل التخريج. كما أذكر دروس رقص متفرّدة من السالسا والتانجو وأنا في الجامعة. تسرّب الرّقص الشرقي بين المزاح والجد في الحفلات والسّهرات خصوصاً مشاهدة الأجسام اللامعيارية في شكلها أو رغبتها أو كليهما. في فقاعتي في عمّان حتى الغيريون يرقصوا وهو شيء طبيعي. بعدما أزيح القليل من ثقل “العيب” وجدت تقبّلاً لم أتوٌّقعه في أوساط عدّة كالجامعة والحفلات الخاصة والأعراس وحفلات البارات التي يجلس فيها النّاس في العادة. صرت أتلقى المديح وأنا أخلط الشرقي بغيره من الأنواع في السّهرات وفي نوادي الرّقص الليلي كما الأعراس. حتى بعد هجرتي وجدت أنّه تم طلبي خصّيصاً في حفل زواج أخي في بلدتنا المحافظة في فلسطين إلى قاعة السيّدات حيث وجدت نفسي أفتل عمّة هنا وخالة هناك، والدتي، وأصنع مشهداً يرخي قليلاً من التشنج المحيط وأنا في وسط قاعة أفراح وجميع الأعين والأضواء مُسلّطة علينا على منصة مرتفعة في وسط الصّالة.
جاءت الجائحة بعد حوالي العقدين وأنا في قارّة أخرى بعيداً عن العمل والرّوتين كما العائلة والطفولة وكل ما يذكّرني بهما كفسحة سمحت لي الحصول على تشخيصات أكثر دقّة.علاجات طبيّة وفيزيائية وضبانات أقدام، كلّها تحاول تهدئة قدمي، خصيتي، أسناني، وأوعيتي الدمويّة ونفسيّتي المتعبة. وبعيداً عن تاريخي الطبّي، صارت أصوات أجسادنا تعلوا وسط هدوء الحجر الصّحي ورهبة حظر التّجوال، تذكّرنا بحاجتها للتحرّك وللتّنفّس بعيداً عن خدر شاشات المحمول وتشنّجات الكمبيوتر وتقرّحات التّلفاز. بعيداً عن روتين العمل والمهام، وجبة الغداء الرّتيبة مع الزّملاء، الخروج مساءً، الجنس الروتيني مع الشّريك، وعطل قصيرة هنا وهناك. كل شيء توقّف واختلط التّرتيب، وبقي الجسد يبحلق في نفسه أمام مرآة.
بين شقّتي وشقّق أصدقائي، صالة اليوغا ورقص الجاز والرّقص المعاصر كما سهرات التكنو والإلكترو بعد الحظر وغيرها من السّهرات المتفرّقة يتسلل الرّقص من أردافي وخصري إلى أقدامي، إلى عضلات وعظام ظهري ورقبتي بعد ساعات طويلة على الهاتف أو الكمبيوتر. تنساب الذّبذبات عبر أجزاء جسدي المتشنّجة وتتيح للدّم وللأكسجين الانتشار رويداً رويدا، دون الحاجة للصّراخ والتّشجيع والنّظرات والضّغوطات، كنشاط عفويّ وسمفونيّة جسديّة. أوركسترا تقوم عضلات جسمي بالمساهمة بها مجموعة مجموعة. تهدأ وترتاح لتعود مع مجموعة جديدة كل مرّة وتعود في تتابعات وإيقاعات تختارها الدّقات والآلات المختلفة وسرعة اللّحن في سمفونيّة علاجيّة، تسحب فيها العضلات المتناسقة والمُدربّة أخواتها الأقل تناسقاً وترافقها حتى تجد مكانًا لها بين العظام والغضاريف التي تعيد ترتيب نفسها كل مرّة لتحوي حركة جديدة، زاوية أخرى، وسرعة مختلفة.
في باريس بعد انضمامي إلى ورشة فنّانين كمعماري وباحث تاريخي ومصوّر حضري، وجدت نفسي أكثر في صالات اليوغا ورقص الجاز والرقص المعاصر، التحف الأرض وأكسر حدوداً جديدة. أستطيع الشعور مع كل حركة جديدة خروج ذكرى سيّئة خزّنتها ذاكرتي ليس فقط في دماغي، في انطباعاتي، أحكامي وردود أفعالي، بل أيضاً في عُقد غضاريفي وعظامي وفي تشنّجات عضلاتي وفي توصيلاتها. أشرطة تعود بي لسنوات بعيدة، لنظرات وتفاعلات، لأحكام تُطلق، لوشوشات، لهمزات وغمزات ولمزات سريّة استهزائيّة، وربّما مشاعر مختبئة ومختلطة من الغيرة منّي والشّفقة تجاهي من قبل إخوتي، أبناء عمومتي، أولاد الحارة والمدرسة والجامعة وغيرهم من أقراني ومحيطي. أجد نفسي كيان وجسد حرّ يرقص، يفهم، يتخطّى، يسامح، يتناسى، يتعافى.
- Wood Hadley M. and Elder Jack S., “Cryptorchidism and Testicular Cancer: Separating Fact From Fiction,” Journal of Urology 181, no. 2 (February 1, 2009): 452–61, https://doi.org/10.1016/j.juro.2008.10.074.
- “Varicocele: Practice Essentials, History of the Procedure, Problem,” April 9, 2021, https://emedicine.medscape.com/article/438591-overview#a7.