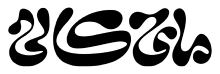بقلم كرار أحمد
العمل الفني: عود نصر
هذا المقال من ملف ‘إنشالله بكرا’ – هيكل العدد هنا
تنبيه: هذا النص يحتوي على مشاهد فيها عنف قد لا تكون مناسبة للجميع
في ال4 من أكتوبر (٢٠٢٠) حزمت أمتعتي لقضاء بضعة أيام في العاصمة بغداد، قبل رحيلي كنت أقرأ بعض كتب الرحالة ممن كتبوا عن بغداد وأنشدوا فيها، وكأن بغداد ذاتها لم تتغير، قرأت أيضًا حينها صدفةً عن حادثة أغتصاب ومحاولة قتل لفتاة مصححة جنسیًا لدى أحد نقاط التفتيش في بغداد كانت قد وقعت سابقا، عبرت عن قلقي لصديقي الذي سيرافقني وقتها، اعتقدت أن لاشيء سيحدث على الإطلاق لكن ذلك كل ممكنًا جدًا، تستطيع الشرطة أن تتمكن منا بسهولة وتدمر حيواتنا دون أن يعرف أحد، كما سيحصل معي بالضبط.
وصلت لبغداد المدينة الصاخبة بأصوات الباعة، المدهشة ببيوتها القديمة والمثيرة للحزن بكمية خرابها. عقدت النية على المكوث هذه الليلة لدى أي صديقٍ يوفر لي ولصديقي الذي سافر معي منزلاً يمكنني الوثوق فيه والاطمئنان له. في اليوم التالي ال٥ من أكتوبر في ذات اليوم المشؤوم، وفي تمام الساعة ال٤ عصرا نويت الذهاب لوسط المدينة لرؤية بعض من رفاقي الذين لايمكنني إيجاد من يشبههم في مدينتي.
أوقفتني مع صديقي في التكسي المتوجه إلى منطقة الحارثية نقطة تفتيش لأحد المناطق ذات الأغلبية السنيَّة في أطراف بغداد، مر التكسي بالسلام على الشرطة ومرر هويته ثم حرك السيارة، لم نلبث ثانيتين إلا والشرطة قد أوقفوا السيارة بعد رؤيتنا وطلبوا النزول للتفتيش، الذي لم يكن فعليا تفتيش ولم يكن طلب مستمسك أصلي.
أجبرنا الشرطي على المكوث في كرفان مغلق كي يحقق معنا ويجلب من معه من الشرطة الآخرين، أريناه مستمسكاتنا المستنسخة ولم يكاد ينظر إليها، حتى رفض أن يراها في الحاسبة الإلكترونية لإحصاء الهويات في أماكن التوقيف، وأستمر بقول «كيف لكم الخروج من بيتكم بهذه الهيئة وبدون مستمسك أصلي، هل ترون وجوهكم حقًا؟» عرف من مكان السكن إننا شيعة، نفوسي في الجنسية المستنسخة من منطقة شيعية جنوبية، أستمر التحقيق الجاري مع شخصين بواسطة مايقارب ١١ شخصًا من مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية، لم أظن مطلقا أن الموضوع يستحق كل ذلك لأن في العادة، يتم قراءة المستمسك الأصلي في الحاسبة لاغير، إلا أن التحقيق لم يكن لهذا الغرض، فَتَّش الشرطة حقيبة سفري المحملة بملابسي دون أي اعتبار للخصوصية، وعندما لم يجدوا شيئًا لم يكن إطلاق التهم والافتراء مهمةً صعبةً لديهم.
اعتبروا مكملاتي الغذائية مخدرات رغم شرحي أنها فيتامينات لما بعد انقضاء فترة شفائي من فايروس كورونا الشهر الماضي، جاء بعد ذلك ضابطٌ أو شرطيٌ آخر، لا أعلم حقا ماكانوا فكلهم يقذفون بالسباب بما يجعلني لا أنظر في رتبهم ولا أركز في مظهرهم، أصبحوا 12 رجلا متحاذق كأنهم من المرتزقة ينتظرون تهمةً جاهزة لإيداعنا في السجن.
الرجولة الطائفية المعسكرة الهشة
لم ينتهي التحقيق بسهولة، أصبح الموضوع عابراً ومنتهکا لكل الحقوق والخصوصيات، بدأ التساؤل حول فكرة «لماذا قد يبات شيعي بهذه الهيئة في منطقة سنية؟» كان هذا شغلهم الشاغل ولم أستغرب بالفعل مايخص هيئتي/جسدي لأن النظام يرى هذا الموضوع أسهل وسيلة للقمع والتعذيب، بل استغربت، الطائفية التي لاتزال تستشري في مؤسسات الدولة قبل المجتمع، كان أغلب المنتسبين شيعة، إن لم يكن كلهم، في نفس المنطقة السنية التي رددوا اسمها وماهيتها للمرة الألف.
رأى أحد الشرطة بعدما فتشني ملصقا بعلم العراق وصورة الشهيد صفاء السراي، كنت اعتبر ذلك من مقتنياتي وذكرياتي الثمينة من الثورة، انفتحت عيناه مع ابتسامة سيئة للغاية حين رؤيته كأنه يقول ها قد وجدنا الإدانة، صورة شهيد وشماغ عربي في الحقيبة مع تزامن عودة الحديث حول إعادة الحراك الشعبي. انتقلت في حديثهم خلال ساعة من شابٍ يبتغي رؤية أصدقائه إلى اتهامي بأني عضو في حركات مخربة أمتلك دراجة نارية أمسكتها السيطرة وحبوب مخدرة وفي طريقي لإجراء فحص شرجي قسري.

العمل الفني: عود نصر
قامت الشرطة بتفتيش هاتفي وبدأوا بابتزازي بأصدقائي والاتصال بهم، ثم الاتصال بأبي وأمي، رافق الحديث والاستجواب بكامله كلمات وجمل في وسط حفلة الشتائم تلك مثل “هل استمتعتم البارحة؟ أعني المتعة تلك”، “كم دفع لكم صديقكم البارحة مقابل الجنس؟”، “ألا يمكنك فحسب أن تكون رجلاً؟”. بعد كل ذلك التعنيف اللفظي والجسدي والتهديد والابتزاز في مساحة مربعة بما يقارب 3×3 متر تكتظ ب١٤ شخصاً، قام الشرطي بمكالمة أهلي وطلب منهم القدوم إلى بغداد وأن لم يسرعوا سيتم نقلي إلى السجن لعدة أيام إلى حين انتهاء مدة الإجراء الاحترازي.
الاحتجاز
“أنهم يدمرون المجتمع” هكذا قال أحد الضباط قبل أن يزج بنا في السيارة. بعد نصف ساعة تم نقلنا إلى المخفر بسيارة الشرطة، وفي مركز الاحتجاز وجدنا منتسبين آخرين وبدأ استجوابٌ آخر. في نظرهم كنَّا هاربين/غير عرب/غير عراقيين/عمال جنس، لم تفارق لسانهم الكلمات البذئية والتهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي من قبيل “هل يمكنك أن تمتعني”، “هل تعتقد أنني لن أؤديك؟ وما هذا الذي على وجهك! لا يمكنك القول أن شفاهك طبيعية”. لم يكن لديهم شيءٌ آخر لقوله، فهم يعرفون كيفية إيذاء النفس.
حرص بقية المنتسبين على إكمال ملف التوقيف بكامل المعلومات وتوقيع تعهد خطي، وتصويرنا بشكل مهين، شريطة أن يكون على سرير الفحص، الفحص الشرجي القسري، بعد ساعة من التعذيب البطيء الذي يشبه قطرات الماء التي تكسر الصخور القاسية، كل دقيقة ترن في الأذن هي مئات الكلمات التي تدوي في الرأس مع نبضات القلب الخافقة بقوة، بقوة الخوف الذي يأكل الروح الذي يرافق أنتظار المصير النهائي لما سيحدث بعد ذلك، مصيرنا المجهول.
بعد تلك الساعة اللعينة، قام عقيد المخفر برؤيتنا على سرير الفحص، الذي سيحدد إن كنا مثليين أم لا، وهذا مرادفٌ للأجرام في لغة الحكومات الأبوية، الحكومات التي جعلت في قاموس قمعها دور الوصاية الأبوية علينا وعلى أجسادنا في الصفحةِ الأولى، فالكل أب، الرئيسُ أب ورجل الدين أب والشرطي أب ومن لا يروق له منظري في الشارع، أب. لكنني لم أعهد إلا أباً واحداً، كان قاسیا بما يكفي لأذكر دور وصايته جيدا.
انتهى الحال بنا في غرفة العقيد «أتحفظ عن الاسم للأمن الشخصي» كنا نرتجي ألّا نتعرض لهذا الانتهاك ونحن على وشكه ظلَ یمن علینا بإنقاذنا من “فحص الشرف” كما أسماه، برر ذلك بأنها حملة لهذه الأيام لتصفية المثليين، وهي ذاتها التي سمعت عنها في الأيام القليلة المنصرمة في كربلاء والنجف وبغداد وعدة محافظات، إجراء احترازي قاتل مع سبق الإصرار ولغرض سياسي، حيث صادف ذلك في فترتها أيضا أضطرابات المحتجين بين الحرمين في كربلاء.
كان العقيد منقذنا الذي أنقذنا دون غيرنا، وغيرنا قد تم رميه بمختلف التهم الملفقة في قاع السجون ليأكل السجن سنينه الباقية في هذا الجحيم المسمى وطننا الجميل، ولكي “لا يعود رجلاً ويراق شرفه” كما قال العقيد، وكما قال أهلي، وكما يرددون بأن هذا ما يقوله الله.
كان العقيد أفضل من في المخفر، أعتقد ذلك لكونه قد عاش التهجير والتهميش فهو صابئي كما أفصح، لكنه ليس بمعزل عن كل جرائم المؤسسة العسكرية التي يرأس أحد مخافرها ويوقع على كل إجراءاتها ونقل منتسبيها، وليس بمعزلٍ عن المغتصبين المتسلسلين في السجون وعن الاعتداءات الجسيمة عن تدمير حياة الناس في ليلةٍ واحدة، كيف يمكن السكوت عن ذلك؟ وكيف يمكن أن تغفو أعين الشرطة قرب نسائهم بعد كل ما يفعلوه؟ ولأي مدى يمكن أن تصل قسوة الإنسان في تدمير حياة أنسان دون تهمة محددة عبر الاغتصاب والتعذيب دون توقف، أو الأحرى “إجراء احترازي”.
لقد كان عنفًا جنسيًا، لم نخضع للفحوص الشرجية التي تجري اغلبها في مناطق النزاع والاضطراب، ذلك ذكرني بضحايا الفحوص الشرجية القسرية من ثورة يناير المصرية والحرب السورية، أتضح الأمر بأن هذا التفتيش المشدد يحصل منذ أول أيام الثورة على الشباب المشتبه بهم ولكنه موجود سابقًا من الأساس.
في غرفة العقيد أكملنا سبع ساعات من التوقيف وانتظار قدوم أهلي، لم يتوقف الاستجواب والاستفهامات في تلك الساعات مطلقاً، ولكنني إلى حد الآن أتساءل حول ما سيفرق من معاملتهم بعد جوابي على أسئلتهم بخصوص ديني، وهل أنا مسيحي أم مسلم، شيعي أم سني، ولكن لن أصل في خيالي وخيالهم لكوني ديني أم لاديني لأن ذلك يعني النوم في السجن لما قد ينسيني كيف يكون ضوء الشمس.
وصل أهلي ورحلت عن المخفر في منتصف الليل، وصلنا المدينة حين بزوغ الفجر ولم ينم لي جفن بعد أن أصبحت في غضون لیلة، غير مرحب فيه بهذه العائلة. بعد تلك الليلة والضغط القاهر، تلك الحادثة الشنيعة، عدت أنا ورأسي الذي يوشك على الانفجار إلى البيت، عرفت منذ كنت في المخفر بأن كل ما حصل لي مع الشرطة وتصادمي مع إجراءاتهم الأمنية هو لاشيء يحتسب أمام ما سأعيشه داخل منزلي بعد هذه الواقعة، كل شيء يصبح أسوا حين أعود للمنزل.
أنا أتكلم عن التوثيق عن حالة لايبوح بها غيري من الشباب الذين تعرضوا لذات الشيء، لقد كانت تصدمني الأعداد ومدى الظلم الذي سمعت عنه، لم أرد أن أجحف حقي بالحديث بشكلٍ موجز، هذا جزء مما عشته أو ما قد يعيشه أي إنسان هنا، أتمنى أن لا يعاد ذلك مع أي شخص، وألا يصمت عن الانتهاك من يواجهه.